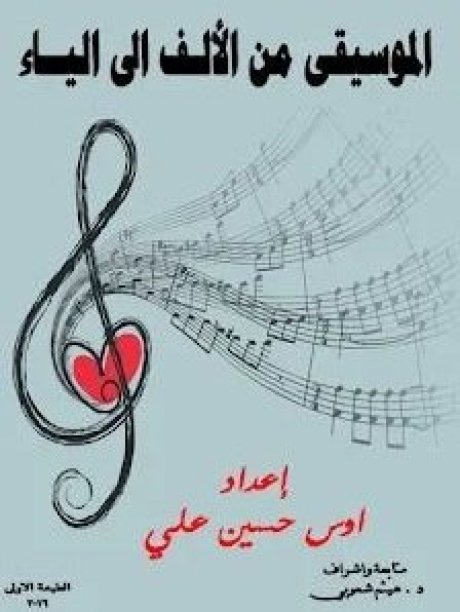أزمة القطاع العام وربيع الليبيرالية

بقلم: صبري الرابحي
غير بعيد عن الوضع العام المتردي و الباعث على القلق، يعيش القطاع العام أزمة قد نعتبرها أزمة منتصف العمر بين إندثار الدولة الراعية و النيوليبرالية التي حولت كل شيء إلى متعامل رأس مالي في دورة إقتصادية مغلقة لا من باب مركزة الإقتصاد على شاكلة المنوال السوفياتي و إنما على شاكلة الوسط الإستثماري المنغلق على خيارات محدودة تحكمها البنوك و مؤسسات القرض بالحديد و النار.
الملاحظ خلال هذه الفترة هو إرتفاع أسهم التعليم الخاص حتى في سنوات التمدرس الأولى، فبعد أزمة الرأس مال الصحي التي كشفتها جائحة كورونا، صرنا نتحدث عن رأس مال تعليمي أصبح خيارا موجعا لعديد العائلات حتى ذات الدخل المتواضع منها دون التساؤل عن المحتوى البيداغوجي و النجاعة في صقل عقول أبنائها.
قد يستفيق التونسيون قريباً جداً على إختفاء المدرسة العمومية ليس إستتباعا لتهميش دورها التربوي-التعليمي فقط و إنما لتحول الحق في التعليم إلى حق نخبوي إجتماعيا على الأقل في ظل تحكم رأس المال في أبسط الحقوق المواطنية التي حسمتها دولة الإستقلال و كانت لزمن غير بعيد "مصعدا إجتماعيا" لمن نسيتهم الأرستقراطية ثم البورجوازية ساعة توزعت "الثروة" جهويا و عشائريا و قطاعيا.
هذه الأزمة في القطاع العام، ككل، يعمقها فقداننا كمواطنين للثقة في نوعية الخدمات المسداة في القطاع العام، والتي للأسف، أصبحت محكومة بندرة وسائل العمل و عدم تأطير منتسبيها حتى صرنا نتحدث عن غياب الأوراق البيضاء و آلات الطباعة و غياب الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصلحة إدارية بسيطة.
صرنا ننساق وراء التهميش المتعمد لمرافق الصحة و التعليم و نذهب إختياريا إلى القطاع الخاص نكاية في "الدولة" التي يغيب عنها ما يحضر لدى رأس المال المتحرر من كل شيء حتى من تشريعاتها البائسة..
هذه "الدولة" الراكنة إلى الخيارات اللاشعبية و إن كانت لا تستحي في المطلق من خياراتها الموجعة فإنه من الجلي أنها لا تستحي من تجهيل أبنائنا و التهاون في حقنا في الصحة العمومية ما دامت لم تستح من قبل من تجويعنا.
الثابت، إذن، أن المال صار يحكم كل شيء، وأن أي مساحة للرفاهية التي قد نستشعرها يوماً ليست سوى بروبغندا الليبرالية لإلهائنا عن وجهها البشع الذي، إن كتب له أكل القطاع العام، فإنه لن يتورع عن أكلنا جميعاً و إنتقاء الناجين منه وفقاً لأصولهم و أرصدتهم، و ذلك هو ببساطة توحش الرأسمالية.
من ناحية أخرى، فإن المدافعين عن تغول القطاع الخاص يجدون أنفسهم في خندق الإنتصار للإنفتاح و إقتصاد السوق و يصطدمون في العادة بهيمنة أطراف بعينها على جل القطاعات في إطار إقتسام السوق و تحالفات رأس المال التاريخية والتي تشكل، بطريقة أو أخرى، المشهد العام و تؤثر مباشرة في الواقع التونسي حتى أنها أصبحت محدداً رئيسياً في الحياة السياسية التي غزاها رجال الأعمال بأموالهم و غاب عنها المثقفون و أفكارهم حتى صارت بلا عنوان و لا تنظير.
المدافعون عن وجهة النظر هذه يصطدمون بحقيقة توحش الخيار الليبرالي في أعتى أزمات الأمم و آخرها جائحة كورونا التي جعلت من الحق في الحياة حقا نخبويا و حولت توفر سرير في المصحات الخاصة إلى ضربة حظ في ظل تزايد الطلب و إنتعاشة رأس المال في ربيع سطوته الإقتصادية و الذي تزامن مع خريف الإنسانية.
لقد أصبح الأمر أكثر من محير في ظل غياب الوعي السياسي و حالة النكران المرضي لجميل القطاع العام الذي أثث، و لو بإمكانياته البسيطة، فترة بناء الدولة الحديثة وما زال يقف سنداً للطبقات الشعبية التي آن الأوان لشحذ وعيها الطبقي أمام خطر تغول سلطة رأس المال التي تجاوزت كل الخطوط الكلاسيكية التي رسمها المواطن و تطاولت على أبسط حقوقه المواطنية، فلم يعد من الوارد مخاطبة إنسانية رؤوس الأموال بقدر مخاطبة أنانيتهم تأصيلا لفكر آدام سميث الذي كان و لا يزال عرابهم إلى ذلك فيما إكتفت الحكومات المتعاقبة بلعب دور الكاردينال الصامت أمام بوح الليبرالية بأنه يتوجب أن يكون لكل شيء ثمن، حتى لو كان الإنسان نفسه.