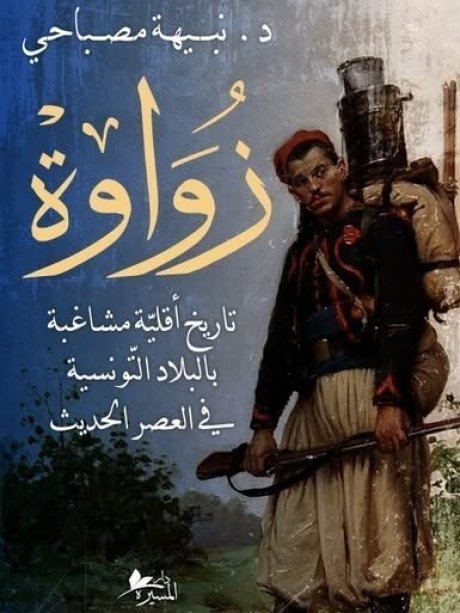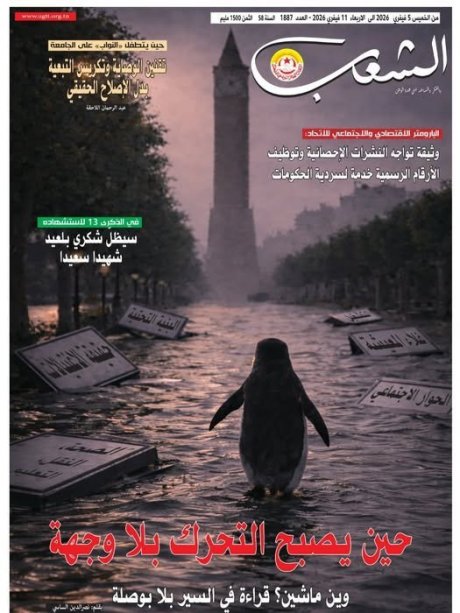حين يتكلم الخراب بلسان الشعر : قراءة عاشقة في قصيدة "أصداء الحوافر في زمن مائل" للشاعر محمد العربي

بقلم الاستاذ مراد اللحياني
إنّ قصيدة محمد العربي "أصداء الحوافر في زمن مائل" ليست نصًّا عابرًا في دفتر الشعر، بل هي من تلك النصوص التي تتوهّج كجرس داخلي في أعماق القارئ، فلا يملك إلا أن يتورّط فيها إلى النهاية.
هي قصيدة تُكتب كما لو أنّها قدر، كما لو أنّها شهادة على زمنٍ منكسر، أو كأنّها نبوءة خرجت من فم شاعر اختبر مرارة الانهيار الكوني، فجعل من اللغة مرآةً للكارثة، ومن الصور أعمدةً متداعية لمعابد مهجورة.
منذ الأسطر الأولى، نشعر أنّ الأرض والسماء ليستا فضاءين طبيعيين، بل صورتان وجوديتان متحوّلتان:
"السماء قليلة / تدور الأرض أسرع مما يجب / أشعر بخفقات السنين في صدري"
إنّها بداية تنقلب فيها الطبيعة إلى قلق: السماء تضيق، الأرض تسرع، والزمن يخفق في الصدر كضربات قلب متسارع. هنا تتأسس بنية النص: كل شيء يتحرك أسرع مما ينبغي، كل شيء يتقلص ويتوتر، وكل ما كان من المفترض أن يمنح الطمأنينة يتحول إلى عبء. وكأن الشاعر يعلن منذ البداية أنّنا على أعتاب قصيدة لا تعرف الاستقرار، قصيدة تنبض باضطراب الكائن والكون.
ثم يتجلّى التكرار والملل في هيئة طقسية:
"ولتكن مشيئتك أيتها التكرار / ولتغمرنا أيها الملل بفيضك السخي"
هنا يستدعي الشاعر قاموس الدعاء والابتهال، لكنه يمنحه للرتابة، للملل، للتكرار. إنّها مفارقة تهزّ القارئ: المقدّس أصبح للفراغ، والعرفان منح للعدم. هكذا يضعنا النص أمام قلب جوهري للقيم: لا قداسة إلا لليومي المبتذل، ولا فيض إلا في الملل، ولا مشيئة إلا للتكرار.
إنّه شعر يكتب ضد اليقين، شعر يُؤلّه الهشاشة، ويصوغ العدم في هيئة معبود. وهذه الجرأة الأسلوبية هي ما يجعل النص مشحونًا برؤيا تراجيدية عميقة.
ثم يفتح النص أبواب التاريخ، لكن دون احتفاء ولا حنين:
"هل ورثت نظرة الأجدد إلى فلوات موحشة / انكسار حوافر خيولهم / صهيل أسئلة مربكة"
هنا تتحول الذاكرة إلى ساحة خراب. الخيول – التي طالما مثّلت رمز القوة والفتح – تنهار حوافرها، والأسئلة نفسها تصهل كما لو أنّها خيول تائهة. التاريخ لا يظهر بوصفه إرثًا مجيدًا، بل بوصفه سلسلة من الانكسارات، وحصيلة من الأسئلة الجريحة. بل إنّ النص يذهب أبعد: حتى الآلهة تنهزم، وتترك فجوات في الزمن وندوبًا على الذاكرة. هذه ليست صورة عابرة، بل إعادة صياغة للوعي: كل ما كان مطلقًا ومقدسًا، كل ما كان حاميًا وراعيًا، انهزم وتركنا في فراغ مرعب.
ولأنّ الماضي منهك، فإنّ المستقبل لا يبدو أوفر حظًا. في مشهد الأحفاد، يكتب الشاعر مأساة الغرق الكوني:
"لن يتذكر الأحفاد سوى أن سفنًا محطمة ألقت بهم في شباك جديدة / سكارى في العتمة التي يغمرها الماء / بالكاد يلتقطون أنفاسهم / إلى أن يتفرقوا كل إلى نهره"
إنها من أكثر الصور فتكًا: الأجيال المقبلة تولد في العتمة، على سفن محطمة، في شباك غريبة، في ماء خانق، بالكاد يتنفسون، ثم تتفرق مصائرهم إلى أنهار متباعدة. هنا تكتمل الرؤيا: لا ماضٍ يمكن الاتكاء عليه، ولا مستقبل يمكن الركون إليه. نحن في ملحمة غرق، حيث الكل ينجرف، حيث المصير هو التفتت والانقسام، لا الاجتماع ولا النجاة.
وحين يعود الشاعر إلى ذاته، فإنه لا يجدها إلا في مواجهة الذاكرة:
"أحمل أفكاري من سيول الأمس / وأبني أعشاشًا للنسيان"
يا لها من استعارة مدهشة: الأفكار ليست نتاج عقل، بل سيول جارفة، والنسيان ليس فقدًا سلبيًا، بل بناء هشّ مثل عشّ. هنا يتجلى الوعي بالهشاشة: كل ما نملكه أعشاش للنسيان، وكل ما نبنيه قابل للانهدام. هذا الكشف ينسجم مع مجمل النص، إذ يعيدنا دائمًا إلى هشاشة الكائن أمام قسوة الزمن.
وتأتي النهاية كصرخة نبوءة:
"سيأتي برابرة من كل صوب / وسيهدمون كل قلاع الصدف الممكنة / إني أسمع صدى حوافرهم في الأيام"
إنها نهاية مفتوحة على الفزع. البرابرة قادمون من كل الجهات، يهدمون حتى احتمالات الصدفة، حتى الفرص الصغيرة للنجاة. وما يزيد الأمر فداحة أنّ الشاعر يسمع صدى حوافرهم لا في الأرض، بل في الأيام نفسها. الزمن كله صار ساحة معركة، والبرابرة لا يغزون المكان فحسب، بل يغزون الزمن ذاته.
على مستوى البنية، النص يتحرك عبر ثلاث دوائر متداخلة:
دائرة الكون (السماء، الأرض، السنين، الأيام)، حيث يتجلى الضغط الوجودي.
دائرة التاريخ (الأجداد، الآلهة، الخيول، المعارك)، حيث يتجلى الخراب الجمعي.
دائرة الذات (الأفكار، الذاكرة، النسيان)، حيث يتجلى الوعي الفردي الهش.
وهذه الدوائر تلتقي في نقطة واحدة: الإنهيار، الفقد، المأساة. لكن هذا الانهيار ليس صامتًا، بل يكتب نفسه بلغة شعرية عاشقة، لغة تجعل الخراب يغني.
أسلوب محمد العربي يقوم على ثلاث ركائز واضحة:
الاقتصاد التعبيري المكثف: كل صورة مشحونة بطاقة كبيرة، جملة قصيرة لكنها تفتح أفقًا دلاليًا واسعًا.
الصور المركّبة المتداخلة: الحوافر ليست مجرد حركة، بل صهيل للأسئلة، والسفن ليست مجرد وسائل نقل، بل مصائر غارقة.
الإيقاع الداخلي: ليس عبر قافية أو تكرار لفظي مباشر، بل عبر تكرار البنى (الخيول/الحوافر/البرابرة) وصدى الصور (الغرق/السيول/الأمواج). وهذا يمنح النص موسيقى داخلية متصاعدة، كما لو أنّه سيمفونية بطيئة للخراب.
إنّ قصيدة "أصداء الحوافر في زمن مائل" هي ترنيمة مأساوية للوجود، قصيدة لا تمنح القارئ عزاءً ولا خلاصًا، بل تمنحه وعيًا أعمق بالفقد. ومع ذلك، فإنّها قصيدة عاشقة، لأنّها تجرؤ على أن تحبّ الخراب، أن تحتضن الملل كفيض، أن تسمع في صهيل الأسئلة موسيقى، وأن تبني حتى للنسيان أعشاشًا. هذه العشقية هي سرّ قوة النص، وهي ما يجعل القارئ يعيش في أثره طويلًا، كأنّ الحوافر ما تزال تصهل في داخله.
القصيدة:
"أصداء الحوافر في زمن مائل"
للشاعر محمد العربي.
السماء قليلة
تدور الأرض أسرع مما يجب
أشعر بخفقات السنين في صدري
انسكاب الايام في بعضها
تشابك المشاعر في خفوت الضوء
لتكن مشيئتك أيتها التكرار
ولتغمرنا أيها الملل بفيضك السخي
مثلما تفيض أرواح أصدقائي بالنقمة
مثلما تفيض عيناي بالفزع
هل ورثت نظرة الأجدد إلى فلوات موحشة
انكسار حوافر خيولهم
صهيل أسئلة مربكة
تنز عرقا غزيرا على جباههم
فيما تنهزم آلهتهم في حلقات المعارك
مخلفة ندوب في الزمن وفجوات مرعبة
لن يتذكر الأحفاد
سوى أن سفنا محطمة ألقت بهم في شباك جديدة
سكارى في العتمة التي يغمرها الماء
بالكاد يلتقطون أنفاسهم
إلى أن يتفرقوا كل الى نهره
أحمل أفكاري من سيول الأمس
وأبني أعشاشا للنسيان
سيأتي برابرة من كل صوب
وسيهدمون كل قلاع الصدف الممكنة
إني أسمع صدى حوافرهم في الأيام."