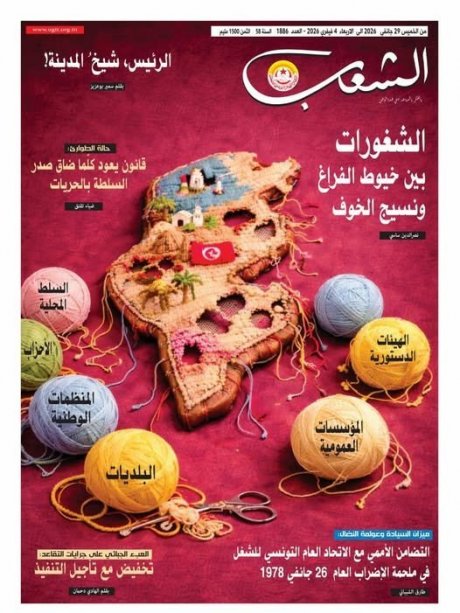جلال الرويسي يكتب للشعب نيوز : البطحاء

بقلم جلال الرويسي - نتسوّغ سكنا لنا في الأحياء الشعبية بضواحي العاصمة. لكنّنا نتوّجه يوميا إلى قلب العاصمة أو ما نسمّيه السونترفيل دون أن يكون لنا غرض محدّد في الغالب. نتقاطر على ساحة محمّد علي من محطة قطارات سكة الحديد وافدين من الضاحية الجنوبية ومن محطّة الأرتال المكهربة قادمين من الضاحية الشمالية ومن محطّات الباصات في حديقة الباساج وباب الخضراء آتين من أريانة والضواحي الغربية، وكأنّ مغناطيسا يسحبنا إلى هناك، نتوجّه في حركة غريزية إلى البطحاء كقطيع لا يحتاج إلى دليل يقوده إلى زريبته.
مدخلان ضيّقان يشقّان عمارات قديمة وشاهقة يفضيان إلى ساحة صغيرة رطبة وظليلة تقع في حي ساخن على تخوم المدينة العتيقة، يحوم حولها مخبرون يتملّون الوجوه في بجاحة ويحسبون الأنفاس على النقابيين المتمسّكين بحقهم في الحياة كطرائد الغزلان والجاموس البرّي غير القابل للترويض.
كلّما دخلت ساحة محمّد علي أحسّ أنّني وقعت في مصيدة. ومع ذلك، لا غنى عن استهلال زيارة العاصمة بإطلالة على الساحة. أقوم بذلك دون هدف محدّد. هي عدوى انتقلت إليّ من الرفاق. وكما لم تنجح تلك الممارسة الطقوسية في إسكات ذلك التساؤل الدّاخلي الذي كان يلحّ عليّ حول الغاية من التردّد على ساحة محمّد علي، فإنّ هذا التساؤل بدوره لم يشفني من الإدمان على زيارة الساحة.
كان الرفاق في الجامعة كلّما أوقف جهاز أمن الدّولة مناضلا يبادرون إلى الاتّصال بقيادة اتحاد الشغل طالبين منها ممارسة الضغط على السلطة والتوسّط في إطلاق سراح الموقوف. وكان الخطباء في الجامعة كثيرا ما يتحدّثون عن البيروقراطية النقابية وتحالفاتها المشبوهة وخياناتها للطبقة العاملة. ولكنّهم كلّما طاردنا البوليس في المظاهرات يصدرون توصية بالاحتماء بدار الاتحاد وتنظيم الصفوف لإعادة انطلاق المظاهرة. وكنّا كلّما أغلق أعوان دار الاتحاد الباب في وجوهنا وحاولوا طردنا من الساحة، نرفع عقيرتنا بالصراخ مردّدين شعارات تتهم قيادة الاتحاد بخيانة أبناء الشعب. من أين كنّا نستمدّ يقيننا بواجب التضامن مع الطلبة المحمول على الاتحاد؟ كانت العلاقة بالاتحاد أشبه ما تكون بعلاقة مراهق متنطّع بوالده المتشدّد.
في ساحة محمّد علي، نتزوّد أغلبنا بالأخبار القطاعية، فترى الواحد منّا، أكان طالبا أو عاطلا عن العمل، يعلم كلّ كبيرة وصغيرة عن قطاعات البريد والصحة والاتصالات والنقل والتعليم والبنوك. يقيّم نتائج مؤتمرات النقابات الأساسية والاتحادات الجهوية، ويتّخذ موقفا من مختلف التحالفات ويعلّق على مسار المفاوضات. هناك أيضا كنّا نتعرّف على قيادات نقابية ونمضي على عرائض المساندة. وهناك أيضا يتصيّد بعضنا النقابيين القادمين من الجهات الدّاخلية ويستدرجونهم إلى المطاعم لسلبهم أموالهم.
في ساحة محمّد علي يرخي الليل سدوله باكرا. فيغلق التجّار دكاكينهم وهم يلعنون حظّهم العاثر الذي قادهم إلى تلك الحفرة التي طار منها الرزق والبركة. ولا يبقى في البطحاء المقفرة ومدخلَيْها المظلمين سوى برد الشتاء وبعض المشرّدين والصعاليك العابرين باتجاه خرائب نهج زرقون. يحدث أن يرابط بعضنا في الساحة إلى وقت متأخّر ملفوفين في معاطفنا البالية نافثين دخان سيجارة نتقاسمها في انتظار أن تختتم هيئة إدارية لقطاع ما اجتماعا حاسما لها حتى نعرف ما إذا أقرّت مواصلة الإضراب أو قبلت بمقترحات الحكومة. كلّ ذلك بتمتمات خافتة وتنقّلات بين الحلقات المعقودة وقوفا في الساحة وبتوجّس تام من نظرات البوليس والمخبرين الذين يحومون في المكان كالضباع تتشمّم مؤخّراتنا لتنقضّ على الخرفان الشريدة والمعزولة.
بطحاء محمّد علي مدرسة نتعلّم بين جدرانها أساسيات النضال والتفاوض والتحالف والتكتيك. ولكن ذلك لم يكن غاية الجميع من التردّد على البطحاء. فقد كان فينا من لا يعنيه منها إلاّ عقد العلاقات والتقرّب من القيادات النقابية وقضاء المآرب الخاصّة.
كان انتمائي للاتّحاد وتحمّلي للمسؤولية النقابية بعد التحاقي بالوظيفة، نتيجة منطقية لانحداري من بيئة عمّالية. كان نوعا من التكريم يرتقي إلى مرتبة الواجب تجاه والدي الذي لم يتخلّف يوما عن المشاركة في إضرابات عمّال المناجم رغم أنّه لم يكن يفهم شيئا عن غاياتها ومحرّكاتها. أذكر جيدا ذلك المسؤول النقابي المحلّي ببطنه البارزة وتسريحة شعره المصبوغ اللمّاع. كان معلوما لدى الجميع أنّه زير نساء ومرتش. لكن شفع له عندي موقف لا أنساه يوم كانت الوالدة في حالة صحية حرجة ولم يوفّر لها المستشفى المحلّي سيارة إسعاف تنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى المتلوي لإجراء عملية جراحية. يومها، توجّه أبي مكتب النقابة وعاد مرفوقا بذلك المسؤول ذي البطن البارزة والصوت الأبح. لم يتطلّب الأمر أكثر من خمس دقائق في مكتب ناظر المستشفى المحلّي، ليخرج المسؤول النقابي مخاطبا أبي: "هيّا اعمارة، جيب المرى خلّي تطلع في الأومبيلونص" وكان ناظر المستشفى يقف وراءه ذليلا. فهمت يومها قوّة الاتّحاد ووزنه. وأحببت النقابة التي أنقذت أمّي.
حافظت على طقوس التردّد على ساحة محمّد علي، ولكنّني صرت أنظر إليها من زاوية أخرى. كنت أشفق على الطلبة الذين يتواجدون معنا في الساحة وأرى فيهم بؤسي وشقائي أيّام كنت طالبا مثلهم، وأدرك في سرّي أنّ غاية كثيرين منهم لا تتجاوز مجرّد الحصول على ما يسكت الجوع وفي أحسن الأحوال، الفوز ببعض القوارير والسجائر.
في نفس الوقت، كنت أستهجن اهتمام فئة من النقابيين بنتائج انتخابات الطلبة في المجالس العلمية بالمؤسّسات الجامعية وتحمّسهم لها بحشر أنوفهم في تحالفات الطلاّب ومحاولاتهم التأثير على نتائج الانتخابات. وكنت أنزعج من تفاعلهم مع النتائج بالابتهاج أو الانكسار. كان اهتمامهم بالحياة الطلاّبية يبدو لي نوعا من المراهقة المتأخّرة. كأنّهم لم يغادروا الجامعة.
ومن خلال تلك الحلقات التي تتشكّل في الساحة وتتفكّك وتكبر وتصغر وتتناسل كفقاقيع الصابون، اكتشفت أصنافا من المناضلين والانتهازيين. كان مشهد البعض مقزّزا وهم يتدافعون لتحية الأمين العام وهو ينزل من سيارته ليلتحق بمكتبه. كانت مكاتب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مزارا للقوّادين والمتزلّفين. ميليشيا من المخبرين الذين يقبضون مقابلا لخدماتهم نقدا أو صحونا وقوارير نبيذ في المطاعم. الاتحاد بالنسبة لهؤلاء ليس أكثر من بطحاء محمّد علي ومكاتب أعضاء المكتب التنفيذي. فهم لم يتحمّلوا يوما مسؤولية ولا شاركوا في مسيرة ولا سهروا على إنجاح إضراب ولا شاركوا في اعتصام ولا حرّروا عريضة أو ناقشوا بيانا.
وفي المقابل، عرفت مناضلين هم النقاوة ذاتها. صرفوا العمر واقفين في بطحاء محمّد علي، يدافعون عن حرمة الاتحاد ووحدته، ويقرّبون وجهات النظر، حتى صاروا لا يرون العالم إلاّ بمنظور نقابي. واجهوا البوليس وتحمّلوا هراوات الميليشيا وفي الساحة سالت دماؤهم وتكسّرت عظامهم. في البطحاء، عاشوا انتفاضات 26 جانفي 1978، و3 جانفي 1984، وحربَيْ الخليج الأولى والثانية وانتفاضة الحوض المنجمي وانتفاضة 17 ديسمبر/14 جانفي 2011... وهناك صنف آخر، شابت شعورهم وذهبت صحّتهم وانطفأت عيونهم في البطحاء. لم يكسبوا من الاتحاد شيئا ولا كانت لهم غاية في ذلك، ولم يفيدوا الاتحاد في شيء يذكر. كانوا حطبا لمعارك انتخابية يحرّك خيوطها بيروقراطيون متنفّذون وقد يحشر فيها أنفه المخبرون ومنتحلو صفة الصحفي. إذا اعترضك أحد هؤلاء في الشارع يبادرك بالسؤال: "هل أنت ذاهب إلى البطحاء؟" أو "هل أنت قادم من البطحاء؟" بالضبط كذلك المتديّن الذي يسألك كلّما اعترضك: "هل صلّيت الظهر؟ هيا نترافق إلى المسجد..." البطحاء هي مسجدهم والنقابة عندهم تحوّلت إلى دين لا يرون العالم والوجود إلاّ من خلالها. إذا مررت بساحة محمّد علي في أيّ وقت، يصادفك هذا الصنف وهو متدثر بذلك البالطو الخشن ومطرق ببصره في الأرض، فيسلّم عليك ويقول لك بصوت خافت "تي وينك ما تظهرش؟" لا يترك لك مجالا للإجابة ويسترسل "هاي الهيئة الإدارية متاع الثانوي منعقدة، ونستنّاوا يخرجشي حد يعطينا الأخبار عن الجو والنقاشات داخل القاعة" هو طبعا ليس أستاذا ولا علاقة له بالتعليم الثانوي... تتذكّر أنّك عشت نفس هذا الموقف في نفس هذا المكان منذ ثلاثين سنة خلت. فتتمتم طالبا لصاحبك الشفاء وتواصل طريقك.
أرأف لحالهم لأنّهم أفنوا العمر في شيء لم يفهموا لا طبيعته ولا حدوده. لأنّه من غير المعقول اختزال الحياة كلّها في النقابة. فهؤلاء لم يتزوّجوا أو فشلت زيحاتهم وضيّعوا أسرهم بسبب النقابة ولم يقرؤوا كتبا ولا سافروا ولا عرفوا مسارح ولا مهرجانات ولا ملاعب ولا متاحف.
ثم جاء زمن كان لابدّ لي أن أنصرف فيه إلى أمر آخر. لأنّه من غير المعقول أن أصرف العمر كلّه في البطحاء. ولكنّني مازلت قادرا على التعرّف بالفراسة على الأجيال الجديدة من المتزلّفين النقابيين والمتصوّفين النقابيين.
ويبقى الاتّحاد وبطحاء محمّد علي مدرسة تربّينا فيها بما فيها، من طهر ومن عهر، من بشر ومن حجر، من شجاعة ومن وضاعة، من نضال ومن نذال، من صداقة ومن صفاقة...